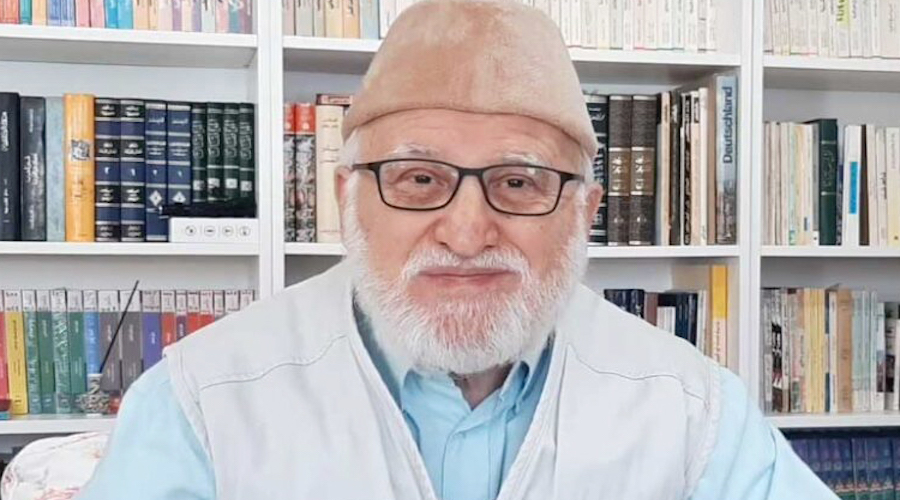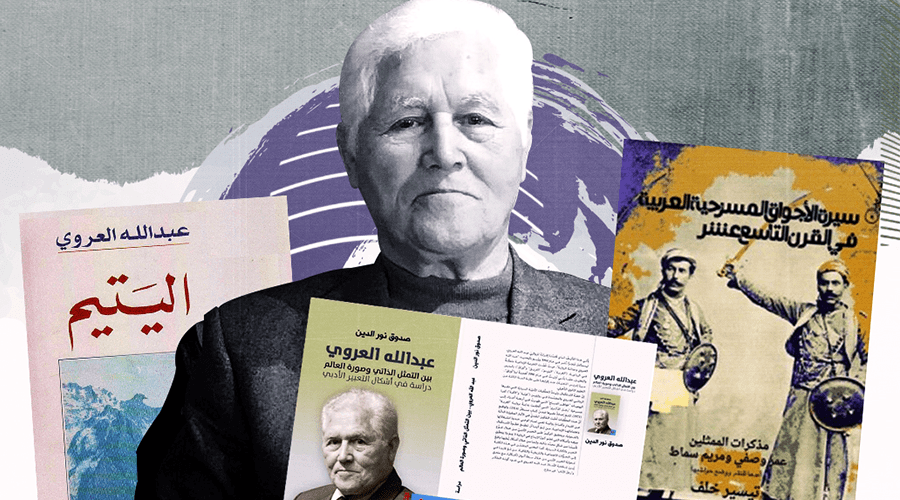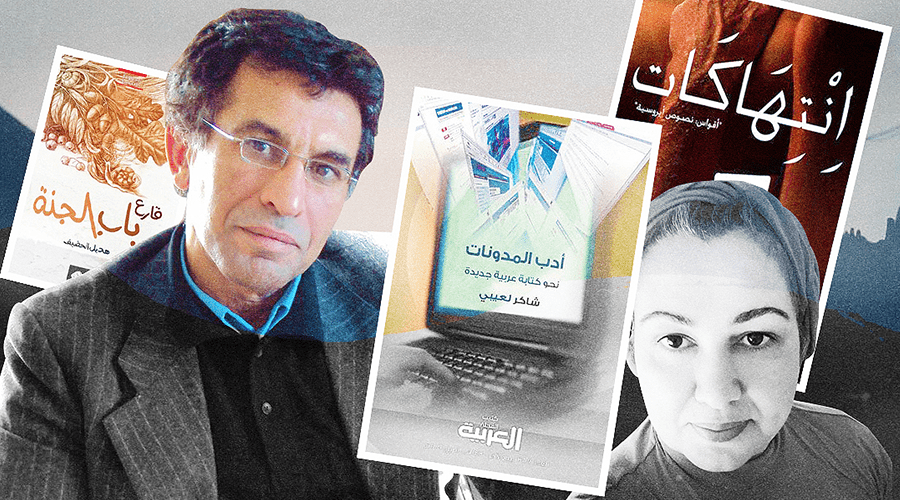الأدباء - الحجر الصحي - كورونا هكذا يعيش الأدباء تجربة الحجر الصحي وهكذا كتبوا عنه

-

تيلي ماروك
نشرت في : 03/04/2020لم يكن الأدب في يوم من الأيام معزولا عن واقعه أو غير متفاعل مع محيطه. وعلى هذا الأساس برزت في هذه الآونة الأخيرة العديد من الكتابات الأدبية التي تناولت موضوع وباء كورونا وما ارتبط به من معاناة إنسانية شكلت صدمة قوية في عصرنا الحديث وأثارت عدة أسئلة عن راهن الإنسان ومستقبله، وتقدير حجم خطورته على البشرية جمعاء. إلّا أنّ موضوع الحجر الصحي طغى على غيره من الموضوعات المرتبطة بهذا الوباء، حيث كانت المناسبة للكثير من الكاتبات والكتاب ليستنطقوا ذواتهم من خلال تجربتهم الخاصة، ويسائلوا واقعهم ويتأملوه لحظة إثر لحظة، ويسجلوا بالتالي جلّ أطوار هذا الحجر الصحي وتفاصيله اليومية، ما جعلها في الغالب تصاغ على شكل يوميات وفي حالات أخرى نصوص شعرية أو قصصية غايتها أن تواكب هذا الحجر الصحي في أهم أحداثه وظروفه العامة والخاصة.

فاطمة الزهراء الرغيوي.. يوميات الحجر الصحي
فكرتُ أولا في الكُتب. قال أخي: والأكل؟ فكرتُ فيه أيضا ولكن الوقت سوف يكون طويلا. سوف أدرس في انتظار أن يبتعد الموت. عندما صعدتُ في الترامواي كان ذلك الشخص المتعرّق يضع كمامة ويمسح العرق البادي عن جبينه، ابتعدتُ بشكل لا إرادي. وعندما جلست بعيدا نظرت إليه، شعرت أنه متحرّج جدا. كان يقف مواجها للباب، مديرا ظهره للناس. شعرتُ بالخجل. أنا مثل الآخرين، خائفة من العدوى. هل أذهب لأقول له إنني أتمنى لك الشفاء؟ لم أفعل، تماما كما لم أتوقف البارحة لأواسي الفتاة التي كانت تبكي بحرقة. لستُ شخصا جيدا. لستُ شخصا مثاليا. أنا مجرد شخص يفكر في الحلول العاجلة. تدبّر أمر الوقت والمال والعزلة. منذ أيام وأنا أحاول ألا أستسلم لنوبة الهلع. اليوم فكرتُ في من أحبهم وقد أصبح غير ممكنا أن أزورهم إلى أجل غير مسمى. إنني أعيش تجربة هائلة. منذ سبعة أشهر، أجرّب أن أكون وحدي، ووحدي الآن أختبر بعدا آخر للعزلة. أحتاج في هذه اللحظة لشِعرٍ يداوي هذه الغربة. أفكر في الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد، تلك السيدة الملآى بالشجن. ربما أقرأ بعض الشعر بعد قليل. ربما أشاهد فيلما. لا مزاج لي لهذا الليل القادم. غدا لن أبرمج هاتفي النقال ليوقظني باكرا. إن كنت محظوظة قليلا، سوف أنام حتى منتصف النهار، هكذا سوف لن يكون لي إلا نصف يوم لأشعر بالعزلة! العالم خائف. أنا خائفة. في غير وقتها، آلام تعتصرني... لن أطمئن على أصدقائي، سأنتظر الصمت الذي يعني أن كل شيء بخير، وسوف لن أرى بيانات النعي. ولن أبكي. الغريبات قويات وصامدات. أريد أن أكتب لكي أكسر حاجز الصمت، ومثلما كنت أفعل صغيرة وأنا أقاوم ظلام ما قبل النوم، سوف أختلق قصصا.

باسم فرات.. يوميات السودان شاعر ورحالة ومصور فوتوغرافي عراقي
اليوم الأربعاء الخامس والعشرون من شهر مارس من سنة 2020 أو سنة جائحة الكورونا. نهضت في الصباح متأخرًا، حوالي التاسعة وهذا وقت متأخر للغاية بالنسبة لي، علمًا أنني في غالب الأيام أنهض صباحًا مع أذان الفجر... قبل يومين كنتُ كعادتي أتمشى فوق سطح العمارة التي أسكن فيها، وأنا أتمشى يوميًّا صباحًا ما بين 20 و60 دقيقة ما بين الثامنة والعاشرة صباحًا، من أجل اكتساب فيتامين «د» وأحيانًا أصعد في المساء المبلل بالنسيم، قبيل أذان المغرب وأمشي ما بين نصف ساعة إلى ساعة، فكانت المفاجأة أن هذا الإمام الذي يذكرني بعرفاء الجيش الذين ينغصون علينا نوم الصباح، أن ألقى محاضرة بعد الصلاة مؤكدًا فيها أن القرآن يحثنا على أن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الاختصاص، وبما أننا نمر بجائحة الكورونا فعلينا أن نلتزم بما يقوله أهل الذكر وهنا هم الأطباء. فرحتُ كثيرًا أن هذا الإمام الذي أشعر به وكأنه يصلني في غرفة نومي، يفعل هذا، ينصح الناس بالإنصات إلى أهل الذكر «الأطباء». شكرًا لكل مَن يستعمل تأثيره من أجل سلامة المجتمع.
في هذا الصباح نفختُ الإطار الخلفي لدراجتي الهوائية وذهبت للتسوق، قبل أن أصل مررت بالشارع الذي يأخذني إلى نهر النيل الأزرق، تجاوزته حوالي عشرة أمتار وعدتُ، فقد قررت زيارة نهر النيل الأزرق، أنا ابن حضارة نهرية، ابن دجلة والفرات، والنيل يذكرني بشريانَي الحياة في وطني، ما أن دخلت الشارع حتى رأيت صيدلية، لم أنتبه لها من قبل وربما هي جديدة، ركنتُ دراجتي وترجلت، سألت عن «الكحول» فأجابتني نعم وجدت أربع علب اشتريتها ومعها علبة خامسة مختلفة، واصلت إلى نهر النيل الأزرق، وقفت قليلًا ودجلة راح يعانق الفرات يؤديان رقصة تشعل الذاكرة وتوقد جمر الحنين. كلما أذهب إلى شاطئ النيل الأزرق، أشعر براحة نفسية، شغفي بالنهر يجعلني أفكر كثيرًا بجذوري، هل شغفي بالماء الجاري سببه جذوري الرافِديني، عند ضفة النهر، رأيت فلاحًا يرتب حقله ويعده للزراعة، سألته بعد السلام والتعارف التقليدي ماذا سيزرع فأجاب «ملوخية» أخبرته بحبي لها ولكنها في العراق ليست لها شعبية، نحن شعب نعشق الباميا والباذنجان وأردت أن أقول له «اليابسة» ولكني التزمت الصمت، التقطتُ مجموعة صور للنهر وللطيور، وغَذّيْتُ بَصَري وحواسي بهذا النهر الذي أحلم أن أرى منبعه مثلما رأيت منبع نهر النيل الأبيض، حولي كان طائر السنونو أو ما شابهه، بعد ذلك استأذنته وغادرت المكان. أحب الفلاحين والعمال والكسبة، هؤلاء روح المكان وعبق المجتمع.
ذهبت للتسوق ومن عادتي أن أشتري الموز والبطيخ الأحمر والبرتقال وبعض الخضروات من شابين يُدعى الأول «محمد» والثاني «محمود» وهو المسؤول عن البطيخ الأحمر والبرتقال. وفي أثناء التسوق اقترب مني «محمد» كثيرًا فأوضحت له خطأ ما فعل، وأن عليه أن يترك مسافة هي التي يُطلق عليها «مسافة الأمان» ولو بحدها الأدنى؛ إذا كان الشعب السوداني معروفا بطيبته فإن «محمد» يملك طيبة مضاعفة عن كثير من السودانيين. ولكنه مثل كثير من السودانيين وحتمًا العراقيين وغيرهم لا يقتنعون بخطورة فايروس «كورونا» وشخصيًّا أعزي الأمر إلى أن الشعوب التي ابتليت بأنظمة لم تعمل على تثقيفها تثقيفًا جيدًا، فهو وكثير من الناس هنا يملكون نقاء مذهلًا، ولكنهم لا يستوعبون كيف أنني أقوم بجلب حقائب قماش وبلاستيكية معي وأجعله يضع الخضروات والفواكه فيها ولا أسمح له أن يضعها في حقائب بلاستيكية (أكياس، وباللهجة العراقية «عِلّاقَة») جديدة منه، وكلما حذرته هو وبقية الناس من خطورة البلاستيك على الناس وما يسببه حرقها يبتسمون غير مصدقين ما أقوله، والشعب السوداني إحدى عاداته هو حرق البلاستيك مع فضلات الطعام.
اليوم «محمد» حين حذرته من فايروس «كورونا» ردّ عليّ بكل ثقة «أن لا كورونا في السودان» هكذا يؤمن هذا الشاب الطيب النقي اللطيف الكريم، مثله مثل ملايين من السودانيين والعراقيين وغيرهم بأن فايروس «كورونا» لا يدخل في بلدانهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشكلة كثير من الناس الذين لم تسمح ظروفهم بتلقّي تعليم جيد يخشون الخطر فقط حين يكون ماثلًا أمامهم، هم يخشون الأسد والكواسر والوحوش لأنها مادية، يمكن رؤيتها، لكن كثيرًا منهم لا يخشون شيئًا لا يُرى بالعين المجردة، وهذه معضلة يجب أن يُلتفت إليها.
حال عودتي للبيت، وضعت ما تسوقته «المسواق» وغسلتُ يديّ ووجهي جيدًا، ثم خلعتُ ملابسي ووضعتها بعيدًا، وعدتُ وغسلتُ يديّ جيدًا، وشربت ماءً وبدأت بتناول فطوري وكان فطورًا يقترب من منتصف النهار، بعد راحة أخذت أقل من ساعة، خرجت لالتقاط صور لتجديد الإقامة السنوية، في محل التصوير التقط لي صورة وبعد دقائق سلمني أربع صور، دفعت له مائة وخمسين جنيهًا سودانيًّا، وخرجت لأذهب إلى المدرسة أسلمهم الصور وأعود إلى البيت وأقوم بما قمت به سابقًا، غسل يديّ والمفاتيح وخلع ملابسي بعيدًا ثم غسل يديّ جيدًا، وإذا بها الساعة الثالثة بعد الظهر «الزوال» وأنا لم أكتب ولم أقرأ جيدًا، فقررت أن أدوّن هذا اليوم، راجيًا أن لا أضطر إلى الخروج خلال الأيام الخمسة القادمة لو أمكن.. البقاء في البيت أسلم.

فريدة العاطفي: صباح الخير أيّتها الحياة كاتبة مغربية مقيمة في فرنسا
الأربعاء 18 مارس/ فرنسا: اليوم الثاني من الحجر الصحي...
الحجر الصحي كلمة جديدة وغريبة، إنها سجن دون أن تكون سجنا، إقامة في مستشفى دون أن تكون مستشفى ولا إقامة فيه... أحسست أنني في فترة زمنية قصيرة أصبحت أعيش في زمن آخر غير الزمن، وكوكب آخر غير الكوكب، حتى الناس لم يعودوا هم نفس الناس، فجأة في ومضة عين أصبح الناس متساوين على الكرة الأرضية، أصبحنا نحمل نفس الأحاسيس، ونوعا من الخوف لم يسبق أن عشناه، هو خوف جديد لأنه مركب، خوف من المرض، خوف من الموت، خوف من الفقد، خوف من الجوع، خوف من المجهول. خوف علينا وخوف على أحبابنا. بأي سلاح نفسيّ سنواجه كل هذا الخوف؟ أعددت فنجان قهوة وصوت بداخلي يقول: ربما علينا أن نبحث في أعماقنا عن قوة نفسية تراكمت بداخلنا عبر سنين من الخيبات والأفراح والوحدة والصخب والأمل والألم والانهزامات والانكسارات. لعل القوة النفسية هي تفاعل دقيق بين كل هذه المشاعر، نملكها جميعا بداخلنا وبدرجات متفاوتة، هناك من يعرفها لأنه يستعملها، وهناك من تاهت منه... وهذه فرصة لنبحث عنها كلؤلؤة ثمينة، ونتعلم بعد ذلك ألا نفرط فيها.
ملأت حوض الحمام بالماء ورميت عليه صابونا مع ورد أحمر مجفف... ودخلت فيه، سأفرغ رأسي من كل الأفكار وأسلم كل حياتي ولو لثوان للماء والورد والصابون.
شكل الورد الأحمر المجفف على الماء جميل، أتابعه يسبح بهدوء... بهدوء... يقترب ويبتعد... فتبتعد مع طيفه أفكاري القلقة... تبتعد... تبتعد... إلى أن تنكمش وتنام... أفكارنا مثلنا تنام وتستيقظ... وهي تستيقظ كلها دفعة واحدة في المراحل الصعبة من الحياة... لذلك تكون متعبة.
بدأت أفرغ رأسي من الأفكار شيئا فشيئا حتى أصبحت كريشة طاووس خفيفة ملونة وجميلة، لم أعرف كم قضيت من دقيقة في الماء؟ لماذا يقولون ولد الإنسان من التراب وسيعود للتراب؟ أحس أن الإنسان ولد من الماء ويجب أن يعود للماء...
كلما دخلت في الماء أحس أنني أعود إلى بطن أمي، ثمة علاقة غريبة بين بطن الأمّ والماء، أحس أيضا بأنني بحاجة لماء من نوع آخر... أحسني بحاجة إلى الحب... ولا شيء غير الحب.
خرجت من الحمام بإحساس لذيذ ومنعش، شغلت موسيقى صامتة تساعدني أن ألتقط كل هذه الأحاسيس الجديدة التي أشعر بها.
على الفايس بعثت لي إليزابيت، وهي جارة فرنسية في السبعين من عمرها، دعوة للانضمام إلى مجموعة كونها الجيران على الفايس: سموها « hello voisins» غريب منذ سنين وأنا أعيش في هذا الحي لا يكاد الناس يعرفون بعضهم، والآن، الآن انتبهوا إلى أهمية التواصل بين الجيران... أجد الأمر مثيرا وإيجابيا.
الصفحة بدأت تمتلئ بأشخاص يدخلون يقدمون أنفسهم، ويتحدثون عن الورود التي بدؤوا يزرعونها في حدائقهم وعلى شرفاتهم... لا أحد يتحدث عن الفيروس... جميعهم يتحدثون عن الحياة... أكبر انتصار على الخوف، هو عدم الاستسلام له... أكبر انتصار على الخوف... هو الانتصار للحياة...
صباح الخير أيتها الحياة...

جمال القصاص : إلى «كورونا» شاعر مصري
أنا خائفٌ...
هل سيظل في الأسبوع سبعةُ أيام
في السنة أربعة فصول
في كفي خمسة أصابع
هل سيظل هذا الوجه وجهي
أيهما أجمل في الحبّ: الكلمات التي قلتها لكِ
أم التي لم أقلها
الأمر لا يتعلق بالعزلة
شربناها في طبق الحساء
نسينا كراريسها في المعبد.
أنا خائفٌ
من يدي من أصابعي من ملمس النور.
خائفٌ من التاريخ
من الشعر من الرسم من اللغة من الكتابة.
خائفٌ من البحر
من النهر من زرقة السماء
ثمة شيء مجنون اندلق على وجه الأرض
لا نحسه لا نراه لا يبالي بهشاشتنا بغبارنا
وأننا نخطئ كثيرا في تدوين أحلامنا
لا نعرف أين نضعها: قربَ الروح أو فوق الرّف أو في قفص الجسد.
أيها الوباء الهمجي اللعين
أيها اللص المجنون اكشف غطاءك
قل لي: ماذا تريد سوف أعطيك إياه
صدقني
أنا أكثر جنونا منك طمئن.. سأحافظ على سمعتك الطيبة القذرة
لن أسخر من تواريخ موتك أو ميلادك
سأدونها بكل الدقة والشفافية
سيكون من العدل أن أهبك اسما جديدا
ربما يصلح لأغنية سنكتبها معا
لرواية لا أبطال فيها
لقصيدة تأخرتْ كثيرا في الذهاب إلى الحقل
أشياء كثيرة من الممكن أن نلعبها معا
لكن أرجوك ابتسم بحبّ وأنت تجرجر قدميك كسلحفاة عجوز
خرجت للتو من المصح.

رشيد بلفقيه.. الوباء كاتب مغربي
استشرى الوباء القاتل بصورة مفاجئة في الأماكن المغلقة، ووجدنا أنفسنا في الشارع، بعد أن طلب منا إخلاء المنازل بسرعة.
-الخطر في الداخل!
-الموت يتربص بكم هناك! من أجل سلامتكم أخرجوا بسرعة، هذا ما رددته مكبرات الصوت. فاكتظت الشوارع بالأطفال والشيوخ والنساء والرجال...
يفتك الوباء بكل من يتجرأ على الدخول إلى بيته. الذين غامروا في البدايات من أجل جلب أغراضهم ماتوا بسرعة بعد ساعات. يكفي أن يغلق عليك باب منزلك حتى تتحول إلى جثة هامدة، تخبرنا قصاصات الأنباء.
-هي مؤامرة لتقليص استهلاك الماء والكهرباء، علّق جارنا الذي يفتي في كل شيء، قالها بنبرة الواثق وضرب بيده في الفراغ، وحق الله! ...
-ماشي بعيد ! علق جارنا الآخر الذي يوافق الجميع ولا يخالف أحدا في السر وفي العلن.
رغم البرد كان الأطفال يتقافزون في البداية مثل الجراد، الشاشات التي تركناها مشتعلة ظلت تعرض لنا تدابير الدول الأخرى التي وصلها الوباء لحل الأزمة، كنا نسترق الرؤية وفهمنا أن التحدي -الآن- هو توفير الدفء للملايين التي فاضت بها الساحات وشقوق الميادين والمنتزهات. ما أسوأ البقاء خارجا، ليت المرض كان هنا وكنا نحن هناك، في غرفنا، على الأقل كنا سنغلق علينا الأبواب في انتظار الفرج. – يا لحظنا، لو فقط كان الأمر معكوسا، وطلِب منّا البقاء في البيوت؟
– يا للهول كيف نبقى في الخارج كل هذا الوقت، كيف سنتحمل هذا؟ يستحيل...
الجميع كان مرتبكا، زاد الارتباك مع مجيء قطرات المطر التي بدأت تبلل وجه الشوارع، حيث الكل يروح ويجيء متجنبا الأماكن المغلقة. بحثا عن ملجأ، بدوري كنت هناك مشردا مع المتشردين.
علا صراخ طفل:
-ماما عييييت!! أريد العودة للبيت.
-حرمنا الداخل !!
– في الداخل كل شيء، يمكنك البقاء هناك قرنا بلا مشاكل، النت الماء والسرير والغرف ... آه!
ظن الجميع في البداية أنها مزحة ثقيلة أو سحابة صيف عابرة، لكن الشاشات المضيئة من هناك، من خلف النوافذ ظلت تنقل الأخبار السيئة باستمرار.
المكلفون بتدبير الأزمة كانوا يوزعون رخصا استثنائية لمن يرغب في الدخول لجلب غرض مهم، بشروط قاسية، أغلقوا الأبواب واستمروا في التعقيم.
فهمنا معنى أن «الداخل» كان حلم المشردين والنازحين وضحايا النكبات، لم نكن نهتم بذلك، كان التمدد داخل الغرفة طيلة اليوم، أمرا بديهيا.
الآن صار حلما قضاء الحاجة في مرحاض بباب مغلق، تبا للأقدار.
الخارج فضاء مفتوح بلا نهاية، بلا حدود، إنه يشبه الهاوية التي لا قاع لها، إلى متى يمكننا الاستمرار في هذه الفوضى؟
الشاشات لم تتوقف عن عرض أرقام المفقودين الذين غامروا بالدخول إلى بيوتهم، ومكبّرات الصوت مستمرة تردد: «بأوامر رسمية، استمروا في التحرك خارجا، الداخل موبوء!»
-«استشرى الوباء» !
كانت تلك البداية، ثم علقنا جميعا في العراء..